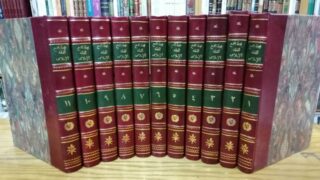طوح الزمان بالأمة الإسلامية في عهودها الأخيرة إلى وضع من الحياة جديد لم تكن له سابقة في ماضيها، وهو وضع المغلوبية الحضارية لأمم أخرى، ذلك الذي أصبحت فيه تابعة بعدما كانت متبوعة، ومغلوبة بعدما كانت غالبة. ومن إفرازات هذا الوضع الجديد أن نشأت ظواهر متعددة من وجود إسلامي لا يكون الإسلام فيه هو القيم على حياة المسلمين الاجتماعية إن بصفة كلية أو بصفة جزئية، وما عاشته كثير من الشعوب الإسلامية طيلة القرنين الماضيين من حياتها تحت استعمار الأمم الأوربية يعتبر إحدى أبرز تلك الظواهر وأكثرها توليدا وتفريعا في خصوص هذا الشأن.
وإذا كانت سنة الله تعالى في تدبير حياة الناس كثيرا ما ينساق إليهم فيها ما ينفعهم ويكون لهم فيه خير إن هم استثمروه بالاعتبار وفق تلك السنة ضمن ما يصيبهم من ضرر وهم له كارهون، فلعل من تجليات هذه السنة في خصوص ما نحن بصدده أن أفرزت تلك الحال الاستعمارية للشعوب الإسلامية التي خضعت فيها لسلطان غير سلطان الدين وضعا من الوجود الإسلامي بالبلاد الأوربية أصبح على صعيد العد يقدر بعشرات الملايين، وأصبح على صعيد الآمال يستشرف التعارف الحضاري أخذا وعطاء بما لم يتسن للمسلمين من قبل، بالرغم مما اتصفت به جهودهم من العزم والإخلاص، وكان هذا التجلي لتلك السنة يتمثل فيما ساقه الله تعالى فيها من خير نافع للإسلام والمسلمين، وذلك في ثنايا ما كان فيه كره لهم متمثل في خضوع هذه الأقليات الإسلامية الكبيرة في حياتها الاجتماعية لسلطان غير سلطان دينها، وهو سلطان القانون الوضعي في تلك البلاد التي تعيش فيها. ولكن ذلك الخير مشروط في حصول خيريته بحسن استثمار المسلمين لمقدماته حتى ينتج ثماره وفق قواعد الاعتبار وقوانينه.
أ ـ ضرورة التأصيل لفقه الأقليات:
ولعل من أهم ما يستثمر به هذا الوضع للأقليات المسلمة بالبلاد الأوربية من قوانين الاستثمار المنتجة للخير منه، هو أن يؤخذ بالمعالجة الشرعية وفق منهج علمي هو منهج التأصيل الذي تُبنى فيه الأحكام والفتاوى لهذا الوجود الإسلامي كي يثمر ثماره الخيرة على أصول وقواعد من أصول الاجتهاد وقواعده، توجهها وتسددها نحو أهدافها على اعتبار خصوصية الوضع الذي تعالجه بالنسبة لعموم الوضع الإسلامي الذي جاء النظر الفقهي العام يعالجه وفق الأصول والقواعد العامة في الاجتهاد.
وقد اهتم الفقه الإسلامي المعاصر بوضع الأقليات الإسلامية في أوروبا منذ بعض الزمن، واتجه إليه بالمعالجة الشرعية التي أثمرت فقها من الفتاوى والأحكام ظلت تثري الحياة يوما بعد يوم، وتوج ذلك الاهتمام بنشوء مجمع علمي خاص بهذا الشأن هو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ولكن هذا الاهتمام المتزايد بشأن الوجود الإسلامي بأوربا، وما أثمره من ثمار، وما تراكم به من فقه، ظل يفتقر إلى الحلقة الأساسية من حلقات النظر الفقهي التي من شأنها أن توجه الاجتهاد وترشده في معالجة شأن هذا الوجود ليبلغ مداه المأمول، ألا وهي حلقة التأصيل الفقهي متمثلا في تقعيد أصولي فقهي لفقه الأقليات مختص به، ومبني على مراعاة خصوصية الوضع الذي يعيشه المسلمون بالبلاد الأوربية من جهاته المختلفة.
ولا يظن ظان أن هذا التأصيل الفقهي لفقه الأقليات سيكون بدعا مستأنفا مقطوع الصلة بالمنهج العام لأصول الفقه الذي يوجه النظر الفقهي، وإنما هو ليس إلا فرعا من فروع ذلك المنهج أو قسما من أقسامه وبابا من أبوابه يشترك مع ذلك المنهج العام فيما هو مشترك بين حياة المسلمين مطلقا عن الظروف والأحوال، ولكن توجه فيه عناية النظر التأصيلي إلى خصوصية وضع الأقليات المسلمة بأوربا من حيث واقعه الخاضع فيه لسلطان القانون الوضعي، ومن حيث ما ينطوي عليه من أبعاد دعوية وآمال مستقبلية، تلافيا في ذلك لنقص في مدونة أصول الفقه شرحنا أسبابه آنفا، ولينتج منه فقه للأقليات المسلمة يتجاوز الفتاوى الظرفية والأحكام الجزئية التي تعالج وجودا إسلاميا ظرفيا عارضا في مقاطع متفاصلة، ليكون فقها يستجيب لآمال الدعوة في تلك البلاد تحقيقا للتعارف الحضاري نفعا وانتفاعا بما لم يتحقق من قبل على الوجه المأمول.
ولا يكون هذا التأصيل الفقهي لفقه الأقليات موفيا بالغرض المبتغى منه إلا بأن يبنى في منهجه على أصول ومبادئ موجهة، تقوم عليها أركانه وتتأسس قواعده، ويتوجه بها منهجه وتنطبع بها صبغته العامة، وبأن يشتمل في محتواه على قواعد وقوانين اجتهادية تستنبط وفقها الأحكام ويتوجه بوجهتها الفقه التفصيلي، ويكون كل من تلك الأصول الموجهات وذلك المحتوى من القواعد والقوانين، مأخوذا بنظر خاص يستجيب به لخصوصية الوجود الإسلامي بأوربا، وذلك في نطاق نظر عام مستجيب للمقتضيات الشرعية للوجود الإسلامي المطلق عن الزمان والمكان.
ب ـ المبادئ الموجهة لتأصيل فقه الأقليات:
هي مبادئ أصول من المقاصد العامة للدين مصاغة باعتبارات وضع الأقليات المسلمة بحسب ما يقتضيه ذلك الوضع من مقتضيات تتحقق بها مقاصد الدين فيه، وهو ما تكون به أصولا ذات طابع كلي شمولي تهدف إلى أن تنتج فقها لا يجعل من المعالجات الشرعية الجزئية لآحاد المشاكل ونوازل الأفراد هدفا نهائيا له، وإنما يجعلها طريقا لهدف أعلى منها، وهو هدف نشر الدعوة الدينية في الربوع الأوربية لينبسط بها الدين الحنيف فيها فينقذ المسلمين فيها من الضياع، ويشهد على غير المسلمين بالتبليغ، فهي إذن ليست مجرد أصول فنية تفضي إلى قواعد للاستنباط الصحيح للأحكام والفتاوى في شؤون الأقليات المسلمة من مداركها الشرعية، وإنما هي أصول تنطوي بالإضافة إلى ذلك على بعد دعوي تبليغي تحتل فيه مقاصد الدين العامة ومغازيه الكلية الموقع المرموق. ولعل من أهم تلك الأصول التي تتأسس عليها هذه المعاني ما يلي:
أولا ـ حفظ الحياة الدينية للأقلية المسلمة:
وذلك لتكون هذه الحياة -في بعدها الفردي والجماعي- حياة إسلامية في معناها العقدي الثقافي، وفي مبناها السلوكي والأخلاقي، انتهاجا في ذلك منهج المواجهة لما تتعرض له هذه الحياة من غواية شديدة من قِبل الحضارة الغربية في بنائها الفلسفي والثقافي والسلوكي، والمواجهة أيضا لمغلوبية حضارية متمكنة في شعور تلك الأقلية من شأنها أن تبسط لتلك الغواية منافذ واسعة للتأثير الذي يعصف بالتدين في النفوس والأذهان كما في الأخلاق والأعمال، فيكون إذن من الموجهات الأساسية في التأصيل الفقهي لفقه الأقليات أن يبنى هذا التأصيل على مقصد حفظ الدين في خصوص الأقليات المسلمة بأوربا؛ وذلك حتى تحافظ على وجودها الديني الفردي والجماعي وجودا قويا صامدا في ذاته، وناميا مؤثرا في غيره.
وإذا كان هذا الموجه المقصدي للتأصيل لفقه الأقليات يعتبر موجها لعموم التأصيل الفقهي، ما تعلق منه بفقه الأقليات وما تعلق بغيره، إلا أنه في توجيهه لتأصيل فقه الأقليات يكون مستصحبا لمقتضيات ما يكون به حفظ الوجود الديني للأقليات المسلمة بناء على خصوصية الظروف التي تعيشها والتحديات التي تواجهها، وهي مقتضيات قد تختلف في كثير أو قليل عن مقتضيات حفظ الدين في الوجود الإسلامي الذي يكون فيه المسلمون يملكون أمر أنفسهم في تطبيق سلطان الدين على حياتهم، إذ الظروف غير الظروف والتحديات غير التحديات، فتكون إذن مقتضيات الحفظ غير المقتضيات، وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الأصل الموجه لتأصيل فقه الأقليات.
ثانيا ـ مراعاة خصوصية أوضاع الأقليات:
الأقليات المسلمة بالغرب -على وجه الخصوص- تكونت في أساسها بموجة من الهجرات من البلاد الإسلامية عبر مراحل متتالية من القرن العشرين، ولم يكن المنضمون إليهم من الذين أسلموا من أهل الغرب إلا أعدادا قليلة بالنسبة لعدد المهاجرين. وقد كان أغلب هؤلاء المهاجرين إلى أوربا على وجه الخصوص من طبقة العمال، ثم انضم إلى العمال طلبة العلم، ثم انضم إليهم المضطهدون السياسيون، ثم انضمت إليهم أعداد من العقول المهاجرة، وبالتراكم الزمني أصبح لهؤلاء المهاجرين أبناء وأحفاد شكلوا ما يُعرف بالجيل الثاني وأصبح الآن الجيل الثالث قيد التشكل.
إن القاعدة العريضة للأقليات المسلمة بالغرب هي قاعدة مهاجرة بدوافع الحاجة، إما طلبا للرزق، أو طلبا للأمن، أو طلبا للعلم، أو طلبا للظروف المناسبة للبحث العلمي، فكان هذا الوجود الإسلامي بالغرب هو في عمومه وجود حاجة لا وجود اختيار، وليست فكرة المواطنة الشائعة اليوم بين هؤلاء المهاجرين مشيرة إلى ضرب من الاختيار إلا تطورا لا يتجاوز عمره سنوات قليلة، وهي فكرة لم يعتنقها بعد القسم الأكبر من الأقلية المسلمة بالغرب. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأقلية جاءت تحمل معها هويتها الثقافية، وقد ظلت محافظة عليها بشكل أو بآخر من أشكال المحافظة، وهي بذلك وجدت نفسها في خضم ثقافة غربية مغايرة لثقافتها، بل مناقضة لها في بعض مفاصلها المهمة، وليست هذه الهوية في مستكن المسلم هي مجرد هوية انتماء شخصي، بل هي أيضا هوية تعريف وتبليغ وعرض في بعدها الديني والحضاري.
ومن هذه العناصر المتعددة في وجود الأقلية المسلمة بالغرب تكونت خصوصيات عديدة يجب أخذها بعين الاعتبار في التأصيل لفقه الأقليات، حتى يكون هذا التأصيل موجها ذلك الفقه بحسب ما تقتضيه الظروف الواقعية، إذ من المعلوم أن الاجتهاد ينبغي أن يكون مبنيا على فقه الواقع كما هو مبني على فقه الأحكام.
ولعل من أهم تلك الخصوصيات التي ينبغي اعتبارها في هذا التأصيل ما يلي:
خصوصية الضعف:
تتصف الأقليات المسلمة -بوجه عام- بصفة الضعف التي لا تكاد تفارق أي أقلية إسلامية في العالم، وإذا كانت حال الضعف حالا ملازمة للأكثر من الأقليات في العالم، فإنها ليست حالا لجميعها، بل من الأقليات من هي على حال من القوة تفوق قوة الأكثرية التي تعيش بينها، ولكن الأقليات المسلمة تفوق في حال ضعفها الأكثر من الأقليات في العالم لأسباب متعددة سنذكر بعضها لاحقا.
ويبدو هذا الضعف أول ما يبدو في الضعف النفسي، فهذه الأقليات هي -في أغلبها- منتقلة من أوساطها الإسلامية إلى وسط ثقافي واجتماعي وحضاري غريب عنها، وهذه النقلة إلى مناخ غريب من شأنها -لا محالة- أن تحدث في النفس شعورا بالغربة الثقافية والاجتماعية، فالاستقرار بالمنبت في المجال الإنساني كما في المجال الطبيعي هو دائما مبعث للشعور بالاطمئنان النفسي المتأتي من الانسجام مع المحيط، والهجرة في المجالين أيضا مبعث للشعور بضرب من القلق النفسي جراء عدم الانسجام مع المحيط الجديد إلى أن يتطاول العهد، وينشأ الانسجام. والشعور بالاغتراب والقلق هو ضرب من الضعف النفسي.
وينضاف إلى هذا المظهر من مظاهر الضعف النفسي ما يستكن في نفوس الأقليات المهاجرة من شعور بالدونية الحضارية أو المغلوبية الحضارية، فالمهاجرون المسلمون إلى الغرب، وهم أكثر الأقلية، انتقلوا من مناخ حضاري متخلف في وسائله المادية والإدارية، إلى مناخ حضاري باهر التقدم في ذلك، وهذه النقلة بين المناخين مع ما يصحبها من مقارنة دائمة تسفر عن تبين استمرارية دائمة في الفوارق من شأنها لا محالة أن تشيع في النفوس شعورا نفسيا بالدونية والانهزام، وذلك ضرب من ضروب الضعف النفسي.
وينضاف إلى ذلك الضعف النفسي ضعف اقتصادي، إذ الأقلية المسلمة في أوربا على وجه الخصوص هي من أكثر الأقليات ضعفا اقتصاديا، إذ هي -في أكثرها- من اليد العاملة أو من الحرفيين، أو من الموظفين في قلة قليلة، وكل أولئك هم على حافة الكفاية إن لم تكن حافة الكفاف، وهو ما انعكس على طريقة الحياة كلها من السكن وسائر المرافق الأخرى، كما انعكس أيضا بصفة سلبية على قدرة هذه الأقلية على تطوير نفسها وتحقيق برامجها وأهدافها التربوية والثقافية والاجتماعية، وقدرتها على الاندماج في الحركة الحضارية والاستفادة منها الاستفادة المثلى.
ومن مظاهر الضعف أيضا الضعف السياسي والاجتماعي، فبالرغم من أن عددا كبيرا من الأقلية المسلمة أصبح من المواطنين الأوربيين، فإن المشاركة السياسية لهؤلاء ما تزال ضعيفة جدا، إن لم تكن معدومة، فالتأثير السياسي الذي من شأنه أن ينشأ عن تلك المشاركة هو أيضا على غاية من الضعف، ولذلك فإن هذه الأقلية يكاد لا يكون لها اعتبار يُذكر في القرار السياسي في البلاد التي تعيش فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للوضع الاجتماعي، فليس لهذه الأقلية مؤسسات اجتماعية ذات أهمية وتأثير لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، واندماجها في المؤسسات الاجتماعية العامة اندماج ضعيف لا يكاد يُلحظ له أثر، ومحصلة ذلك كله أن الأقلية المسلمة بالغرب هي من الضعف السياسي والاجتماعي بحيث يكاد لا يُلمح لها وجود، ولا يكون لها أثر، وشتان في ذلك بينها وبين أقليات أخرى أقل منها بكثير عددا، ولكنها لقوتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ترى آثارها فتحسبها هي الأغلبية وليست الأقلية. وهذا الوضع من الضعف المتعدد الوجوه ينبغي أن يكون ملحَظا معتَبرا عند التأصيل لفقه الأقليات.
خصوصية الإلزام القانوني:
البلاد الغربية بصفة عامة يحظى فيها القانون باحترام كبير، سواء في الحس الجماعي، أو في دوائر التنفيذ؛ ولذلك فإن سيادة القانون فيها يُعتبر أحد الثوابت التي بُنيت عليها ثقافتها وحضارتها، ومن ثم فإن أيما منتم إلى هذه البلاد من فرد أو جماعة، سواء بالإقامة أو بالمواطنة، فإنه سيصبح تحت سيادة القانون السيادة الكاملة، مهما كان وضعه العرقي أو الديني أو الثقافي.
والقانون في هذه البلاد مبني على ثقافة المجتمع ومبادئه وقيمه، وهو منظم للحياة العامة على أساس تلك الثقافة والمبادئ والقيم، ويطبق هذا القانون على الأقلية المسلمة كما يُطبق على سائر أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وهو تطبيق يمتد من أحوال الفرد إلى أحوال الأسرة إلى أحوال المجتمع بأكمله في قدر كبير من الصرامة النظرية والفعلية، بحيث يكاد لا يترك استثناء لخصوصية فرد أو مجموعة تمارس فيها تلك الخصوصية خارج سلطان القانون، وهو ديدن الدولة الحديثة في السيطرة الإدارية المحكمة على المجتمع، وإن تكن تلك السيطرة بتفويض من المجتمع نفسه.
في هذا الوضع تجد الأقلية المسلمة نفسها ملزمة بالخضوع للقانون، وتطبيقه في حياتها حيثما يكون له تدخل في تلك الحياة، وخاصة ما كان يتعلق بالعلاقات العامة بين الأفراد والجماعات، أو بينهم وبين الدولة، والحال أن تلك القوانين كثير منها يخالف المبادئ الدينية والثقافية التي تكون هويتها، وتشكل التزامها العقدي، وهكذا ينتهي الأمر إلى سيادة قانونية على حياة الأقلية معارضة في كثير من الأحيان لقوانين هويتها، فإذا هي ملزمة بالخضوع لتلك القوانين، أو هي إذا كان الموقف موقف خيار بين الدخول في معاملات يحكمها القانون وبين عدم الدخول فيها فإن عدم الدخول يحرمها أحيانا كثيرة من ميزات مادية وأدبية يتمتع بها سائر أفراد المجتمع، وهو ما يعطل كثيرا من مصالحها، ويعرقل من سبل تقدمها.
إن هذه السيادة القانونية على الأقلية المسلمة المعارضة في كثير من محطاتها لضميرها الديني والتزامها العقدي تمثل وضعا خاصا لهذه الأقلية من بين أوضاع عامة المسلمين، فالمسلم وضعه الأصلي أن يكون خاضعا لسيادة القانون الإسلامي، والتكاليف الدينية التي كلف بها إنما كلف بها باعتباره يعيش تحت سيادة ذلك القانون، إذ تلك التكاليف هي -في أغلبها- ذات بعد جماعي كما هي الطبيعة الجماعية للدين الإسلامي، فإذا ما وجد المسلم نفسه ضمن مجموعة من المسلمين هي تلك الأقلية موضوع البحث، ووجد أنه ملزم بأن يكون تحت سيادة غير سيادة القانون الإسلامي الذي هو الوضع الطبيعي لتنظيم حياته الجماعية، فإنه سيجد نفسه لا محالة في تناقض بين واقعه وبين مقتضيات هويته الجماعية، وهو ما يمثل ظرفا خاصا في حياة الأقلية المسلمة بالبلاد الغربية على وجه الخصوص يقتضي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الاجتهاد الفقهي في شؤونها.
خصوصية الضغط الثقافي:
تعيش الأقليات المسلمة في مناخ مجتمع ذي ثقافة مخالفة لثقافتها في الكثير من أوجه الحياة، وهي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع تلك الثقافة في كل حين وفي كل حال، فمن الإعلام، إلى التعليم، إلى العلاقات الاجتماعية، إلى المعاملات الاجتماعية، إلى المعاملات الاقتصادية والإدارية، إلى المناخ العام في الشارع من عادات وتقاليد وتصرفات فردية واجتماعية، بحيث تطغى تلك الثقافة على أحوال المسلم أينما حل، بل تطغى عليه حتى داخل بيته.
ومما يزيد من سطوة تلك الثقافة على الأقلية المسلمة أن هذه الأقلية لم تنتظم أمورها الاجتماعية بحيث تكون لها فضاءات خاصة بها، تسود فيها ثقافتها، فتخفف بذلك من سطوة الثقافة الغربية عليها، ففي فرنسا يعيش أكثر من 5 ملايين مسلم، ولكن ليس لهم مدرسة واحدة منتظمة كامل أيام الأسبوع تمثل فضاء ثقافيا خاصا بهم يخفف عن أبنائهم ما يتعرضون له من غلبة الثقافة الاجتماعية السائدة، ناهيك عن النوادي والمؤسسات الترفيهية إذا ما استثنينا المساجد والمراكز الدينية.
إن هذه الثقافة المغايرة التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في بلاد الغرب بوجوهها المختلفة، وبوسائلها الجذابة المغرية، وبطرق إنفاذها المتقنة، تسلط ضغطا هائلا عليها، وبصورة خاصة على أجيالها الناشئة، وهذا الضغط يصطدم بالموروث الثقافي الذي تحمله هذه الأقلية إن بصفة ظاهرة معبرة عن نفسها أو بصفة مضمرة مختزنة، وفي كل الصور يحصل من ذلك تدافع بين الثقافتين، وينتهي هذا التدافع في الغالب إما إلى الانسلاخ من الثقافة الأصل والذوبان في الثقافة المغايرة، أو إلى التقوقع والانزواء اعتصاما بذلك من الابتلاع الثقافي، أو إلى رد الفعل العنيف على هذه السطوة الثقافية يجد له تعبيرات مختلفة من جيل الشباب على وجه الخصوص.
ومهما يكن من رد فعل على هذه السطوة الثقافية فإنها تُحدث في نفوس الأقلية المسلمة -وبالأخص في نفوس الشباب منها- ضربا من الاضطراب والقلق في الضمير الفردي والجماعي على حد سواء، وهو ما يصبغ الحياة العامة للأقلية بصبغة التأرجح التي ينتفي معها وضع الاستقرار النفسي والجماعي، فلا هذه الأقلية اندمجت في جسم المجتمع الذي تعيش فيه حتى صارت خيوطا من نسيجه، ولا هي كونت هيكلا متجانسا يتفاعل مع المجتمع من منطلق تلك الهيكلية المتماسكة فيما بينها كما هو شأن الأقليات في بعض البلاد الآسيوية مثل الهند، وهو وضع يكتسب من معنى الخصوصية ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في التأصيل الفقهي.
خصوصية التبليغ الحضاري:
مهما يكن من وضع الأقلية المسلمة بالغرب من قوة أو ضعف، ومن استقرار أو اضطراب، فإن مجرد وجود هذا العدد الكبير من المسلمين بالبلاد الغربية يُعتبر ضربا من الصلة الحضارية بين الحضارة الإسلامية -مهما يكن تمثيلها ضعيفا- وبين الحضارة الغربية المستقرة؛ فالمسلمون الذين هاجروا إلى هذه البلاد لا يمثلون مجرد كمية بشرية انتقلت من مكان إلى مكان، شأن كثير من الهجرات التي تقع قديما وحديثا، وإنما هجرتهم تحمل معها دلالة حضارية، وهي دلالة تتأكد باطراد بارتقاء نوعية المهاجرين وتعزز تلك النوعية بهجرة العقول وتمكن المهاجرين في مواقعهم العلمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية على وجه العموم.
وإنما كان الأمر كذلك من بين كثير من الأقليات المشابهة في وجودها بالغرب للأقلية المسلمة لأن هذه الأقلية تحمل معها ميراثا حضاريا ضخما، لئن لم يكن حاضرا الحضور البين الفاعل في واقع التدافع الحضاري، إلا أنه حي في النفوس، مختزن فيها بقيمه ومبادئه الروحية، وبرؤيته في تفسير الوجود وتنظيم الحياة، وبتاريخه الممتد لألف ونصف من الأعوام، فهذا الميراث لم يتركه المهاجرون إلى البلاد الغربية خلف البحار ليصلوا إليها غفلا من التشكل الحضاري، بل أولئك الذين نشئوا بهذه البلاد من الجيل الثاني والثالث لم يكونوا كذلك أيضا، وإنما هم يحملون أقدارا من ذلك الميراث منحدرا إليهم من الانتماء الأسري ومن الانتماء الحضاري العام، ومهما بدا في الظاهر أحيانا من ملامح التخلص من هذا الميراث كما هو متمثل في بعض مظاهر التنصل من مقتضيات ذلك الميراث الحضاري فإنه ليس إلا مظاهر سطحية، أما الضمير فهو مختزن لذلك الميراث.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الميراث الحضاري الذي تحمله الأقلية المسلمة ليس ميراثا طبيعته الانكفاء والسكون، وإنما طبيعته الظهور والعرض؛ وذلك لما انبنى عليه من أصول عقدية توجب على حاملها في ذاتها وحامل مقتضياتها الحضارية أن يعرف الناس بها، وأن يعرضها عليهم عرض بيان واختيار، عسى أن يجدوا فيها من الخير ما يقنعهم فيأخذون به، فيعم إذن نفعه، ولا يبقى حكرا على أصحابه، وذلك هو معنى الشهادة على الناس التي تضمنها قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمة وَسَطا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا} (البقرة: 143).
ومن جهة أخرى فإن هذه الأقلية المسلمة ليس وجودها بمهجرها وجود انبتات عن الجسم الأكبر لأمتها، وإنما هو وجود انتماء إليها وتواصل معها مهما شط بها المكان، ونأى بها المقام، ومهما اتخذت لها من مجتمعاتها الجديدة موطن تفاعل واستقرار، ويقتضي هذا الانتماء والتواصل بمقتضى امتزاجها بالحضارة الغربية امتزاج عيش يومي، ووقوفها عليها وقوفا عن كثب أن تكون أيضا واسطة اقتباس لما هو خير في هذه الحضارة في وجوهها المادية والمعنوية لتبلغها إلى أمتها الإسلامية قصد تعريفها بها، والانتفاع منها في بناء نهضتها.
يتحصل من ذلك إذن أن الأقلية المسلمة في أي موقع وجدت فيه بصفة عامة، وفي موقعها بالبلاد الغربية بصفة خاصة، تمثل حلقة وصل حضاري بين حضارتين، ومن مهامها باعتبار ذلك الموقع أن تقوم بدور تنقل فيه المنافع النظرية من قيم ومبادئ تشرح الوجود وتبين الحياة، والمنافع العملية في وجوهها المختلفة من طرف إلى آخر، وأن تعمل على تأكيد معنى التعارف الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، لتكون سببا من أسباب العمل على البناء الحضاري المشترك لما فيه خير الإنسان، وبهذا الموقع الذي هي فيه، وهذا الدور المناط بعهدتها تكتسب خصوصية ينبغي اعتبارها في التأصيل لفقه الأقليات.
ثالثا ـ التطلع إلى تبليغ الإسلام:
وذلك انطلاقا من وجوده بالبلاد الأوربية في حال الأقلية، وسعيا إلى التعريف به لدى غير المسلمين، انتهاجا في ذلك لمنهج يأخذ بعين الاعتبار المسالك النفسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي منها يمكن أن يأخذ الدين طريقه إلى النفوس بينا واضحا، فينتفع به من أراد الانتفاع، فيكون إذن من الموجهات الأساسية لتأصيل فقه الأقليات أن يبنى ذلك التأصيل على مقصد دعوي لا يقف عند حد حفظ تدين الأقليات وتدعيمه، وإنما يتخذ منه منطلقا للتوسع والانتشار ليراه الناس على حقيقته، فيؤمن به من يختار الإيمان، ويستفيد منه من يرى فيه الفوائد.
ولهذا الأصل الموجه مقتضيات يقتضيها في التأصيل لفقه الأقليات قد لا تكون مقتضاة أصلا في التأصيل للفقه العام، أو قد لا تكون مقتضاة فيه بالحجم نفسه وعلى القدر نفسه؛ وذلك لأن هذا التأصيل إذا كان ملاحظا فيه البعد الدعوي على نحو ما ذكرنا ينبغي أن يستصحب خصوصيات ما تقوم به الدعوة في الظروف الأوربية بمعطياتها النفسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، لينشأ منه بهذا الاستصحاب فقه للأقليات ذو صبغة دعوية لا يقتصر على أحكام وفتاوى تحفظ على الأقليات دينها فحسب، وإنما تصاغ فيه تلك الأحكام والفتاوى صياغة فقهية تبسط من روحها الدينية السمحة إلى النفوس الحائرة والأفكار الضالة والعلاقات الاجتماعية المتأزمة ما تنفتح له طبيعتها بما تجد فيها من أمل العلاج لأزمتها، فتقبل على الدين من خلال ذلك الفقه، ويحقق مقصد الدعوة هدفه بفقه للأقلية موجه في تأصيله بتطلع دعوي يروم التعريف بالإسلام في الربوع الأوربية.
رابعا ـ التأصيل لفقه حضاري:
وهو فقه لا يقتصر على التشريع لعبادة الله تعالى بالمعنى الخاص للعبادة، وإنما يتجاوز ذلك ليشرع في حياة الأقليات المسلمة عبادة لله تعالى بمعناها العام الذي يشمل كل وجوه الحياة الفردية والجماعية في علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، وعلاقتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وعلاقتهم بالمحيط البيئي الذي هو مجال حركتهم، بحيث تتناول أحكام الشريعة في هذا الفقه ما به تترقى جماعة المسلمين في ذاتها الإنسانية ترقية فردية بالعلم والفضيلة، وترقية جماعية بالتراحم والتعاون والتكافل، وما به تكون شاهدة على الناس شهادة قول وشهادة فعل بتبليغ الخير الديني والدعوة إليه، وما به تكون مرتفقة للمقدرات الكونية: استثمارا لها ومحافظة عليها من الدمار، بحيث ينشأ من هذا المبدأ الموجه للتأصيل فقه من شأنه أن يصنع من حياة المسلمين بأوربا أنموذجا حضاريا إسلاميا شاملا خاضعا لله تعالى في شموله لوجوه الحياة.
وهذا الأصل الموجه لفقه حضاري على نحو ما وصفنا يقتضي في فقه الأقليات الإسلامية بأوربا ما يقتضيه النظر الفقهي العام ويقتضي زيادة عليه؛ ذلك لأنه يستلزم أن يكون ملاحظا فيه بقدر كبير الحالة الحضارية العاتية التي يعيش في كنفها المسلمون بأوربا، والتي تغالب في نفوسهم وسلوكهم منزع التدين بسلطان ذي سطوة شديدة، فإذا لم يؤخذوا بفقه حضاري على نحو ما وصفنا يكافئ في عيونهم نفسيا وفكريا، وفي أثره على حياتهم نفعيا ذلك الأنموذج الحضاري الذي يتعرضون لسطوته أو يشف عليه، وترك الأمر لمجرد أن تعالج حياتهم معالجة فقهية تعبدية بالمعنى الخاص، أفضى الأمر إلى أن تكون لتلك السطوة غلبة على النفوس، فتنساق حياتهم في أكثر وجوهها على غير شريعة الله تعالى حتى إن انتظمت فيها شعائر العبادة.
وكذلك يقتضي هذا الموجه أيضا أن يكون ملاحظا فيه بقدر كبير ما هو مترسب في أذهان الأوربيين وأذهان بعض المسلمين المتأثرين بهم من صورة للدين لا يدخل فيها إلا ما هو علاقة روحية بين العبد وربه، ويخرج منها ما هو تنظيم للحياة الاجتماعية وتنظيم لعلاقة الإنسان بالمقدرات الكونية، فتخلو بذلك من البعد الحضاري للتدين الذي يكاد يتمحض فيها للبعد الروحي من حياة الإنسان، وإذا ما لم يؤصل فقه الأقليات تأصيلا حضاريا واقتصر على أبعاده التعبدية الروحية والأخلاقية كرست في الأذهان تلك الصورة المنقوصة للتدين فلم يبق لها أثر ذو بال في التمكين للدين الذي هو مقصد أساسي لفقه الأقليات كما بينا آنفا.
خامسا ـ التأصيل لفقه جماعي:
وهو فقه لا يقف عند حد تزكية الفرد في خوافي نفسه وظواهر أعماله بأحكام الشريعة ليظفر بخلاصه الفردي، وإنما يتخذ من ذلك منطلقا لتزكية الجماعة المسلمة والجماعة الإنسانية في حياتها المشتركة لتكون مهدية فيها بحكم الشريعة، فتجري على التعاون على البر والتقوى، وتنأى عن الإثم والعدوان، وتنتهي إلى الفلاح الجماعي في إثمار الحياة بالتعمير في الأرض، وإلى الخلاص الجماعي من شرور الدنيا وحساب الآخرة.
وهذا التوجيه إلى فقه جماعي يستلزم في التأصيل لفقه الأقليات المسلمة بأوربا ما يستلزمه التأصيل للفقه العام مع زيادة عليه؛ لأن هذه الأقليات تعيش في المناخ الاجتماعي الأوربي الذي تطورت فيه بأقدار كبيرة مظاهر التعاون الجماعي، وبنيت فيه القوانين على ذلك التعاون، كما يبدو إداريا في مظهر المؤسسات الجماعية التي تدير الحياة الاجتماعية الأوربية برمتها، وكما يبدو إنسانيا في تحقيق التكافل بما يحقق الكفاية في إقامة الحياة لكل المنخرطين في المجتمع الأوربي، فإذا لم يكن الفقه المبتغى منه معالجة حياة المسلمين بالمجتمع الأوربي فقها جماعيا يشرع للإدارة المؤسسية، كما يشرع للتكافل المادي والمعنوي بحيث يكافئ في بعده الجماعي جماعية القانون الوضعي أو يفوقها ضعف في إدارة حياة المسلمين من جهة، وضعف في تقديم أنموذج حضاري إسلامي من جهة أخرى، فقصر إذن عن تحقيق حفظ الدين في حياة المسلمين، فضلا عن تمكين الإسلام ونشره بالديار الأوربية.
إن التأصيل لقواعد فقه الأقليات الذي نحن بصدد الحديث فيه إذا ما توجه بهذه الموجهات الخمسة التي نعدها من أهم موجهاته المنهجية، فإننا نحسب أنه تنشأ منه قواعد أصولية فقهية تشكل منهجا في النظر الفقهي بخصوص الوجود الإسلامي بأوربا من شأنه أن يثمر فقها للأقليات يثرى في نطاق النظر الفقهي العام بخصوصيات كفيلة بأن تحقق قدرا كبيرا من النفع بالديار الأوربية.
إن الموجه الأول يؤسس لما به حفظ الدين في حياة الأقليات في مناخ يغري بانحلاله. والموجه الثاني يؤسس للانطلاق من الفقه الواقعي فيكون الاجتهاد مبنيا على علم بالموضوع المبتغى علاجه. والموجه الثالث ينتج فقها دعويا ينتقل بحفظ التدين في حياة المسلمين إلى بسط الدين لينبسط بدائرته إلى غير المسلمين فيقفوا على حقيقته. والموجه الرابع يثمر قواعد أصولية ينشأ منها فقه حضاري يقدم من حياة المسلمين أنموذجا حيا للإسلام الحضاري الشامل في الممارسة الفردية والاجتماعية والكونية يكافئ الأنموذج الحضاري الغالب اليوم.
والموجه الخامس يثمر قواعد ينشأ منها فقه جماعي ينشد فلاح الجماعة الإسلامية والإنسانية من خلال فلاح الفرد بما يشرع من الإدارة الجماعية ومن التكافل الاجتماعي، كما ينشد الخلاص الجماعي لنوع الإنسان من خلال الخلاص الفردي، فكيف يمكن لهذه الموجهات المبدئية العامة أن تؤسس قواعد أصولية تتضمن من المواصفات المنهجية ما تثمر به فقها يمكن من التعريف بالدين في البلاد الأوربية؟
أ.د. عبد المجيد النجار